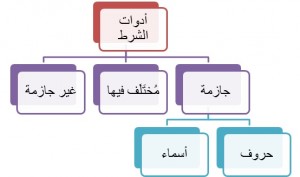المطلب الأول: مميزاته
كتب المحقق كلها عظيمة , ولكن الخالد منها , والذي يحتفظ بملك الزمن له , هو صفائحه الفقهية , وخاصة كتابه الذي عليه البحث المعروف باسم (شرائع الإسلام)[1]
حيث مما يمتاز به هذا الكتاب الأسلوب السلس , والعبارة المشرقة والدقة في تأدية المعنى , والإيجاز في الألفاظ ,والمنهجية الفذة في البحث والموضوعية الأمينة في عرض الآراء[2].
فهو كما يقول صاحب الذريعة عنه (من أحسن المتون الفقهية ترتباً , واجمعها للفروع…)[3]
وقال المقداد السيوري (لم يسبقه أحد إلى مثله في تهذيبه ولم يلحقه لاحق في وضعه وترتيبه)[4]
وقال محمد حسن ألنجفي (ت 1266) صاحب (جواهر الكلام): (إني رأيت كتاب الشرائع) من مصنفات الإمام المحقق ..
قرأنا في الأحكام الشرعية , وفرقانا في العلوم الفقهية , فائقاً من تقدمه إحاطة ومجازا له واتقانا , و أنموذجاً لمن تأخر عنه ولساناً [5].
كما يؤيد ذلك ما ذكره جعفر كاشف الغطاء
المطلب الثاني : شروحه
وقد ضاعف في أهمية هذا الكتاب مكانته انه شرح بمستويات مختلفة وعلى انحاء متعددة ,مزج وتعليق وتحشية وتوضيح ,وهي مستمرة إلى وقتنا هذا إذ بلغت حسب آخر الإحصائيات المائتين[6]
ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون المتعددة فجعلوا أبحاثهم وتدريباتهم فيه , وشروحهم وحواشيهم عليه[7]
وقال صاحب أعيان الشيعة : (كل من أراد الكتابة في الفقه الاستدلالي يكتب شرحاً عليه ونسخه المخطوطة النفيسة لا تحصى كثرة) [8]
بل إن معظم الموسوعات الفقهية الضخمة , التي ألغت من بعد عصر المحقق , شروحه كما توضحه أسماؤها .
فمنها: أساس الحكم …وتقرير المرام …وجامع الجوامع …وجواهر الكلام …حاوي مدارك الأحكام…وشوارع الأعلام …وغاية المرام …. وكشف الإبهام …. وكشف الأسرار …. وكنز الإحكام …. وباني الجعفرية
ومدارك الأحكام ….ومسالك الإفهام …ومصباح الفقيه….ومطالع الأنوار ….ومعارج الأحكام ….وموارد الأنام ….ومواهب الإفهام ….ومناهج الأحكام ….ونكت الشرايع ….وهداية الأنام وغيرها [9]
وأكرر كلام الأعلام لأهميته في ذلك أنه (شرح بمستويات متعددة) وعلى أنحاء مختلفة من مزج وتهميش وتعليق [10]
وأول من شرحه , بعد أن اختصره , هو المحقق نفسه وقد اسماه المعتبر في شرح المختصر [11]
المطلب الثالث: ترجماته
أما ترجماته , فهو من الكتب القلة التي ترجمت إلى لغات عدة حيث ترجمه إلى الفارسية , الشيخ محمد تقي بن عباس النهاوندي المتوفى بطهران سنة (1353هـ) [12]
كذلك ترجمته إلى الروسية (قاسم بك) , والى الفرنسية (كوري ) [13]
وكذلك ترجمته إلى التركية [14]
المطلب الرابع
طبعاته
وقد طبع كتاب (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) عدة طبعات وأعيدت طباعة الكثير منها وهذه الطبعات منها محققة ومنها غير محققة:
- طبعة سنة (1377هـ/1957م) وهي طبعه حجرية, منشورات المكتبة العلمية الإسلامية , طبع مطبعة خورشيد, طهران.
- طبعة سنة (1389هـ / 1969م) بأربعة أجزاء تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال , وقدم لها عميد كلية الفقه محمد تقي الحكيم وساعدت كلية الفقه على نشره , طبع مطبعة الآداب في النجف وفي نفس ألسنة , عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان , قم – خيابان ارم
- طبعة سنة (1389هـ / 1978م) بمجلدين في بيروت
- طبعة سنة (1403هـ / 1983م) بأربعة أجزاء , وهي الطبعة الثانية بتحقيق عبد الحسين البقال , طبع دار الأضواء , بيروت(1) وقال في المقدمة (بناءاً على أهمية الكتاب , وإيمانا بأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله , فقد عمدت إلى نشره ثانية علماً بأنه يمتاز عن تلك الأولى بأمور:
- إنها محققة على نسخة مقروءة على المؤلف نفسه (قدس سره) وعليها خطه الشريف.
- روعي فيها حصر الزيادات التي وردت في المتن بين أقواس , وذلك من اجل توضيح العبارة
- كما ابعد عنها البياضات في الطباعة غير الضرورية كافة.
- صححت التعليقات التي وردت فيها أخطاء مطبعية أو فقهية [15]
- طبعة سنة (1409هـ / 1988م) بمجلدين ، تعليق صادق الشيرازي , طبعة مطبعة أمير , قم .
- طبعة سنة (1415هـ / 1994م) المحققة طبع مؤسسة المعارف الإسلامية , قم.
- طبعت سنة (1427هـ / 2006م) بمجلدين وهي الطبعة الثانية بتعليق صادق الشيرازي , طبع مطبعة ستارة , قم ولازال الكتاب كل ما ينفذ من المكاتب يطبع.
[1] المحقق الحلي , شرائع الاسلام , تحقيق /البقال , م
[2] نفس المصدر , ك
[3] الطهراني , الذريعة ,13/47-48
[4] ألنجفي , جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ,1/2.
[5] التنكابني , قصص العلماء ,202
[6] الجلالي : شروح الشرائع ,328 , الطهراني ,الذريعة (شروع الشرائع ) 13 /316 – 332.م.ن (حواشي الشرائع) , 6/16-108
[7] الطهراني , الذريعة ,13/47
[8] محسن الأمين , أعيان الشيعة , 15/374
[9] المحقق الحلي , شرائع الاسلام تحقيق / البقال 4
[10] الطهراني , الذريعة 13/ 316 – 332
[11] المحقق الحلي :المعتبر في شرح المختصر 3
[12] الجيلي : اعلام العرب 2/97
[13] جاء في دائرة المعارف الإسلامية 8/57-58
[14] المحقق الحلي , شرائع الإسلام, تحقيق / البقال 5
[15] المحقق الحلي :شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام تحقيق / البقال 1