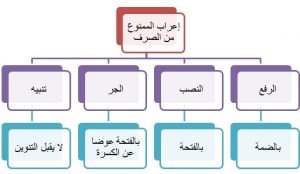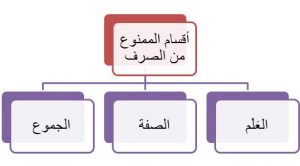رواية ودرس 20
📚 روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع): إن الله عز وجل قال: ( يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تنعمون بها في الآخرة ). الكافي ج٢ ص٨٣.
📜 إن العبادة رابط روحي يربط الإنسان بالمطلق، وعالم الغيب والمعنويات، وبها يتصل القلب بمنعم الوجود اتصالات مختلفة متنوعة، وهذه الإتصالات تجعله يستشعر الرقابة الإلهية، فلا يتجرأ على الإنحراف ويتوجه نحو الإستقامة وطريق الصواب.
📌 وقد أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد على أن العبادة هي هدفُ الخلق، قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ). سورة الذاريات، آية 56.
فلا بُد أن يُعبد الله تبارك وتعالى العبادةَ الحقة، وهي “عبادة الأحرار”، كما عبر الصادق من آل محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام): ( العبادة ثلاث: قوم عبدوا الله خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقومٌ عبدوا الله طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقومٌ عبدوا الله حباً له، فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة ).
الكافي 2: 68|5 وفي نسخة منه: العباد ثلاثة.
📚 وللعبادة مصاديق مباركةٌ عديدة، منها:
١) الصلاة: وهي ابرز مصاديق العبادة، وهي حصنٌ حصين، كما روي عن أميرالمؤمنين (ع): ( الصلاة حصن الرحمن، ومدحرة الشيطان ) شرح نهج البلاغة 313:20 / الحكمة 39.، وفي رواية أخرى عن سيد الفصاحة والبلاغة أميرالمؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام): ( الصلاةُ قُربانُ كلِّ تقيّ ). تحف العقول 73.، فالصلاة – واجبة ومندوبة – تحرك الإنسان نحو الصلاح والإستقامة.
٢) الدعاء: وهو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وكما ورد في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ( الدعاء مخّ العبادة ، وما من مؤمن يدعو الله إلاّ استجاب له ، إمّا أن يعجّل له في الدنيا ، أو يؤجّل له في الآخرة ، وإمّا أن يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ، ما لم يدع بمأثم.) وسائل الشيعة ج7، ص27.
وفي الرواية كما في وسائل الشيعة ج7، ص28، عن الحسن بن محمد الطوسي في (الآمال): عن أبيه، عن أبي الطيّب الحسين بن علي التمّار، عن ( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن ايوب )، عن يحيى بن عنبسة الجعفي، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ): ( ما فتح لأحد باب دعاء إلاّ فتح الله له فيه باب إجابة، فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا).قال أبو الطيّب: الملل من الانسان الضجر والسأمة ومن الله على جهة الترك للفعل.
٣) تأوه الإنسان لمظلومية أهل البيت (ع): بشهادة المعصومين أن البكاء على مصائبهم ومظلوميتهم عبادة، فيما رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ أنهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصادق ( عليه السَّلام ) يَقُولُ : ” نَفَسُ الْمَهْمُومِ لَنَا الْمُغْتَمِّ لِظُلْمِنَا تَسْبِيحٌ ، وَ هَمُّهُ لِأَمْرِنَا عِبَادَةٌ ، وَ كِتْمَانُهُ لِسِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ” . الكافي : 2 / 226، فهو نوع من أنواع العبادة.
📌 وللعبادة أُسُسٌ وشروط، وأهمها التقوى والورع، وكذلك عدم الرياء وإظهار العبادة، فقد روي عن النبي (ص): ( أعظم العبادة أجراً أخفاها ) سفينة البحار والمجلد الخامس عشر من بحار الأنوار.، وقد روي عن عمار الساباطي، قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا عمار، الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية. رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 38|162.
خادم الآل
الميرزا زهير الخال
النجف الأشرف
الأربعاء ٢١ رجب الأصب ١٤٣٥هـ